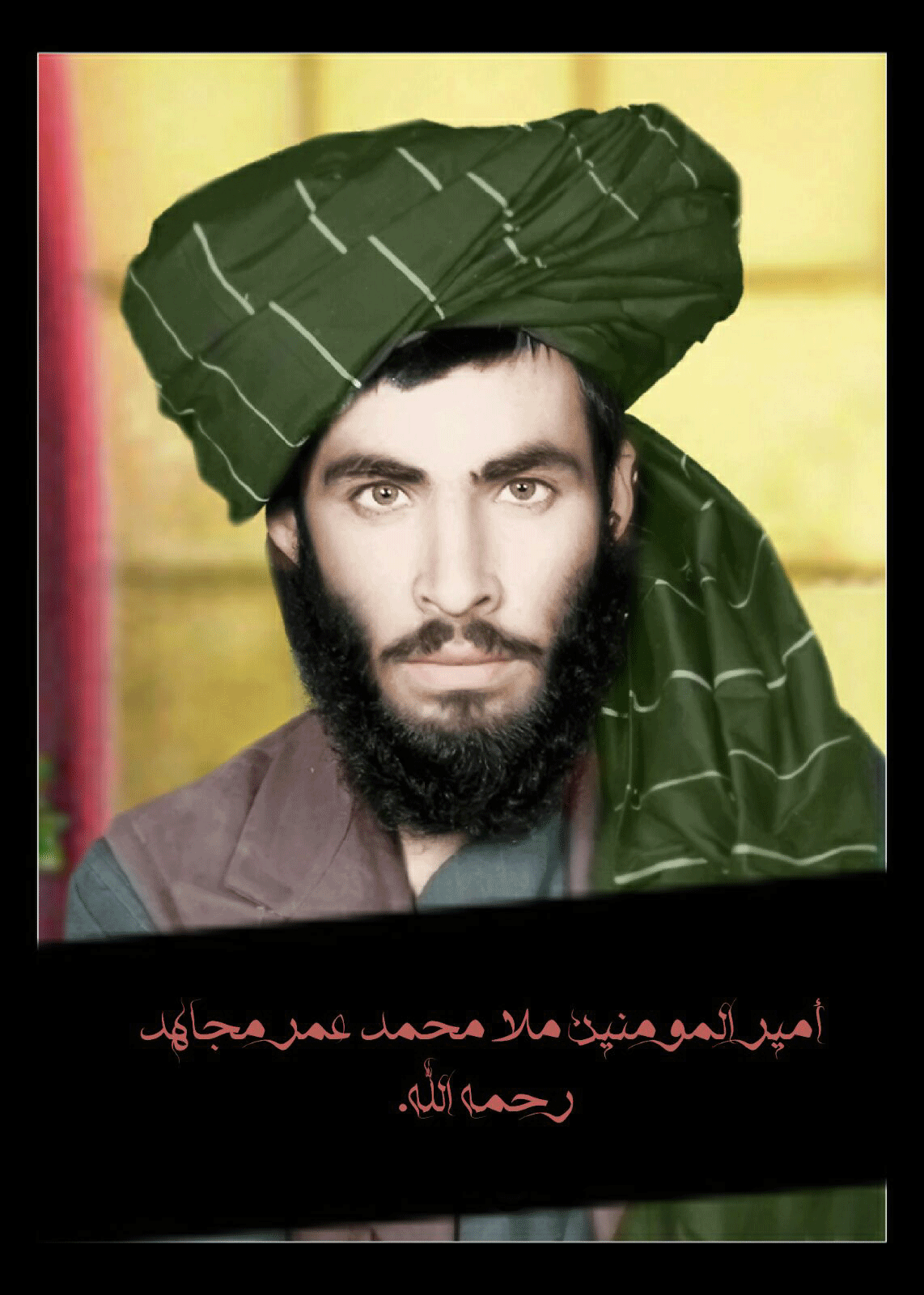منصور الرحمن الغزنوي
إن من سنن الله الجارية التي لا تبديل لها؛ بعث رجال على مرّ العصور لإحياء مفاهيم دينية تضاءلت ونسيها الناس، حتى لا يكادون يعرفون أنها خلق إسلامي سامٍ، وصارت تلك المفاهيم مغمورة عن أعين الناس مطوية في بطون الكتب، حتى عادت مهجورة عن واقع الحياة، هؤلاء الرجال هم المجددون حسب ما اصطلح. وإن الله قدّر في عصرنا الراهن أن يعيش حاكم مسلم يستحق لمآثره ومفاخره أن نسميه مجددا، وهو جدير بهذه التسمية، ألا وهو أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد رحمه الله. حياته بأسرها مغامرات وبطولات وتضحيات قدّمها للإسلام وأهله، لكننا في هذا المقال نتخير بعضها للقراء نماذجاً، أما التفصيل فلا يتحمله مقالنا هذا.
إن أعظم ما قدمه أمير المؤمنين للمسلمين في هذا العصر هو إقامته الخلافة على منهاج النبوة، وإجراء جميع الأمور الحكومية في ضوء الشريعة الإسلامية. والخلافة وإن كانت حتى القرن الماضي إلى نهاية خلافة العثمانيين، لكن الحق الأبلج هو أنها لم تكن تماما حسب النهج الذي تركها عليه الراشدون من الخلفاء، فالنظم الموافقة للخلافة الراشدة كانت قلة في التاريخ المتأخر. لكن بفضل الله أولاً، وبعزيمة الأمير ثانياً، استطاع -رحمه الله- أن يقدم للعالمين أنموذجا من الخلافة الراشدة.
لقد أقام أمير المؤمنين الملا عمر -رحمه الله- نظام الحدود والقصاص وبسط العدل وكانت فيه الغلبة للمظلوم، ووسد الأمور إلى أهلها، وسهل للناس الوصول إلى استيفاء حقوقهم، ونشر الأمن والأمان في المناطق التي كانت تحت سيطرته، وأخمد نيران العصبية الجاهلية، فكان المسلمون بأجمعهم عنده سواء وإن اختلفت ألوانهم وألسنتهم، وحفظ لأهل الذمة حقوقهم، وغير ذلك من الأمثلة لقراراته التي أصدرها أثناء حكمه. وكانت الشريعة الإسلامية هي مرجع القانون والدستور في إمارته، بينما تسود الدول الأخرى -حتى التي تدعي كونها دولا إسلامية- القوانين الوضعية المعادية للشريعة الغراء.
إن العصر الذي نعيش فيه قد اندرست فيه المفاهيم الشرعية الكبرى، وإن المسلمين حتى العلماء منهم– مع الأسف – يرجحون المصالح الوطنية على المصالح الدينية العامة، ويكون الوطن هو المقدم عندهم على الأخوة الإسلامية، لكن المصالح الدينية والشريعة الإسلامية كانتا عند أمير المؤمنين مقدمتين على كل شيء، وكانت الشريعة الإسلامية محط نظره في كل شيء، ونرى ذلك جلياً في عمله بالحكم القرآني المهجور (إنما المؤمنون إخوة)، حيث كان يعرف جيدا أن الأمة المحمدية لا تنحصر في إطار وطني أو لساني ضيق، إنما أبناء الأمة كلهم إخوة، أياً كانوا وأينما كانوا، ما داموا مؤمنين بربوبية الله سبحانه وتعالى وبرسالة لمحمد – صلى الله عليه وسلم -، فكان -كما رأى العالم بأجمعه- أن ضحى بدولته للدفاع عن مؤمن عربي هاجر إلى بلاده، وكانت التضحية بدولته، أهون عنده من تسليم مسلم إلى الكفار، وهذا من النظائر العجيبة لهمته العالية، إذ لا يمكن سبر غور هذه التضحية، وهل من تضحية فوق تلك يا ترى؟
كانت حياة أمير المؤمنين حافلة بإحياء سنن مهجورة، ومن هذه السنن؛ سنة تحطيم الأصنام، كما فعل سيدنا إبراهيم – عليه السلام – حيث قال الله تعالى يحكي عن خليله: (وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون) [الأنبياء: 57، 58]. ثم نرى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة محطما أصناماً كانت في الكعبة وحولها، ثم إرساله بعوثا لتحطيم الأصنام في أماكن أخرى، وما بعثه لخالد وعلي وغيرهما– رضي الله عنهم – بخافٍ على عارف بالتاريخ والسير! ثم نرى في بلادنا العالم الحاكم المسلم السلطان محمود الغزنوي في صفحات التاريخ محييا هذه السنة، حيث يحكى عنه تحطيمه لأكبر صنم في الهند يدعى (سومناة)، وكما لم تصرفه تهديدات البراهمة وأهل دين الهندوس، كذلك لم تصرف أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد تهديدات رؤوس الكفر حول تحطيم صنم بوذا في باميان. وكانت بعض المتاحف الدولية التمست منه بيع ذلك الصنم مقابل ثمن باهض، لكنه أبى ذلك، ليسلك بذلك مسلك محطمي الأصنام، وقال بلسان حاله: لأن أدعى محطم الأصنام، أحب إلي من أن ادعى بائعها!
يدرك العارفون بالسياسة المدنية والعلاقات الدولية وخامة هذه القرارات الحازمة. حتى في عصرنا هذا لا تستطيع دول ذات قوى مادية اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة، لكن أمير المؤمنين في هذه القضية -مثل أخواتها في القضايا الأخرى- اتخذ قرارا حاسما دون أن تسانده قوات مادية وأموال هائلة وجيوش جرارة، لكنه أقدم بإيمانه القوي بقدرة الله، وأن الله هو الفعال لما يريد ولا مصرف لما يريده أحد، وبشجاعته الموهوبة له من الله، وتوكله البالغ على الله -الذي كان يسميه هو توكلا محضا. فترك بهذا أنموذجا رائعاً للأجيال القادمة لا يكاد ينسى على مر الزمان.
كان أمير المؤمنين لا يعرف الخنوع والاستكانة والخضوع أمام الباطل، بل ظل شامخا أبيا حتى وقد أتى عليه زمان تزلزلت فيه أقدام الأقوياء، لكنه وقف كالنخل غير راكع لأحد، دون أن يتأثر بتهديدات الكفرة أجمعهم، مع كثرة عتادهم ووفرة جنودهم.
وفيما يلي نقتبس بعض ما جاء في خطبته قبل احتلال أمريكا لأفغانستان بأيام، والذي يظهر فيها جلياً بسالته وأنه لا يخاف إلا الله. حيث يقول في معرض كلامه: “إن ما أرادته أمريكا من قصف أو اقتحام حرب لن ينصرف عنا بخنوعنا وذلتنا، فلو فعلت ذلك، وشاء الله أن يكون ذلك، فلا مصرف لذلك عنا أبدا! فليواجه المسلون هذا بغيرتهم وبسالتهم ولا يخافوا من هذه الأحداث، فإن قُتِل أحدٌ وقد وقف شامخا بغيرته وشجاعته فأي ملك فوق ذلك! وأي فوز فوق ذلك!… تفكروا في قول الله تعالى: (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)، فهل المعتمد قول الله أم ما قالته أمريكا؟”
هذه الخطبة بأسرها مثال عجيب على الحمية الدينية والغير الإسلامية لموقف المؤمن الموحد بالمعنى الحقيقي الكامل -نحسبه كذلك-.
هذه لمحة يسيرة من مآثره ومواقفه، وإلا فحياته بأسرها حافلة بأمثال هذا، رحمه الله وأسكنه بحبوحة جنانه!