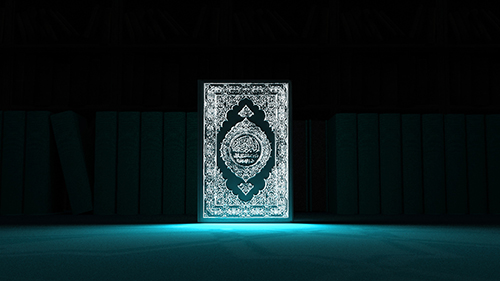خصائص الدعوة الإسلامية: [6- العدالة. 7- السماحة واليسر. 8- الحكمة. 9- صالحة لكل زمان ومكان. 10- شريعة الإحسان]
محمد بن عبدالله الحصم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فما زال حديثنا يتواصل في خصائص الدعوة الإسلامية، وذكرنا خمس خصائص، وهي: الربانية، والرحمة، والعالمية، والدعوة الحق، والوسطية. ونذكر في هذا المقال بعضها أيضا فمنها:
الخصيصة السادسة: العدالة
العدالة في الإسلام خصيصة عنوانها: إعطاء كل ذي حق حقه. قال تعالى: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان” الآية، وليس الإسلام دين مساواة كما يخطئ كثير من الناس فيربط العدل بالمساواة ويستدل بالحديث الشريف: “ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم”.
والصحيح أن المساواة إنما تكون حقا في الأمور المتساوية، فالمستحقون لحقوق متساوية تمنح لهم حقوقهم بالتساوي، ولا يفضل بعضهم على بعض. أما المساواة مع الفوارق فليست من الحق بل من الباطل المذموم، ومن الظلم الذي يُنزّه الله عنه، فالحديث السابق المقصود به المساواة في ميزان الله وأجوره، فالبشر جميعهم سواء عند الله، فأقربهم إليه وأكرمهم عنده أتقاهم وأسلمهم قلبا، وأعظمهم أجدرا أكثرهم إخلاصا وإحسانا، فلا فرق في العمل في العبادات المشتركة بين جنس وآخر والثواب على هذه العبادات بين إنسان وآخر، حتى الذكر والأنثى.
أما المساواة بين الذكر والأنثى في الواجبات والحقوق فمن الظلم والباطل، لأن الذكر ليس كالأنثى، والعدل هو أن الذكر يصلح لأمور لا تصلح لها الأنثى، فكلف الله الرجل بتكاليف لم يكلف بها المرأة كالجهاد والقتال، والنفقة على الزوجة والعيال. ومقابل هذه التكاليف أعطاه من الحقوق فجعل له القوامة على الزوجة مقابل النفقة، فقال تعالى: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”.
وتكليف الرجل بالنفقة دون المرأة ليس ظلما للرجل، بل غاية العدل، لأن النفقة تحتاج إلى عمل وكد وقوة واختلاط بالرجال، وهذا لا يتناسب مع المرأة في فطرتها وتكوينها، فلم تكلف به.
ولما جعل الله الحمل والرضاع في الزوجة، أعطاها حق الحضانة وقدمها على الزوج في هذا الباب، ولما جعل القوة في الرجال كلفهم بالقتال، والمرأة لم تكلف به لأن تكوينها وفطرتها لا يلائم ذلك، وهكذا فلو قال رجل إن على المرَأة أن تقاتل كما نقاتل لأضحك عليه العقلاء والمجانين.
وهكذا في الديات جعل دية المرأة نصف دية الرجل في قتل الخطأ، لأن فقد الرجل أعظم وأقسى على أهله من فقد المرأة، فليس الذكر كالأنثى، ففقده فقد للمعيل، ولما كانت الديات تعويضا عن المصاب أعطى على المصيبة الأعظم تعويضا أكبر.
وكذلك في المواريث يُعطى الذكر ضعف نصيب المرأة، لأن الله ألزمه بنفقات مالية لم يُلزِم بها المرأة، فميراثه سيكون نفقة على زوجته المرأة وأولادها، أما هي فلا يلزمها شيء من ذلك فسيكون الميراث رصيدا لها.
فالله جل في علاه قد فرض على الرجل ما يناسب تكوينه وفطرته، وكذلك المرأة، فطلب المساواة بينهما في كل شيء مع الفوارق الجسدية، والعقلية، والعاطفية، سفه وحمق وإنما يدفع إليه من ألغت شهواتهم عقولهم، ويريدون توريط المرأة في هذه المساواة الجائرة لإخراجها من بيتها لتختلط بالرجال فيسهل إغواؤها.
الخصيصة السابعة: السماحة واليسر
روى الإمام أحمد في “المسند” عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الأديان أحبُّ إِلَى الله عز وجل؟ قَالَ: “الحنيفية السمحة”.
والمقصود بالسماحة: اليسر والسهولة والقرب وعدم التعقيد. قال العلامة العيني في عمدة القاري: “قوله: (السمحة) بالرفع صفة: الحنيفية، ومعناها: السهلة، والمسامحة هي: المساهلة، والملة السمحة: التي لا حرج فيها ولا تضييق فيها على الناس، وهي ملة الإسلام. [عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1/ 235) ب].
وقال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان: “بُعِثْتُ بِالْحنِيفِيَّةِ السمْحِةِ”. فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة. فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. [إغاثة اللهفان: 1/ 158].
فأحكام الإسلام سهلة ميسرة، فلا يصح شرعا تكليف فوق الطاقة، أو ما يزيد على الطاقة المعتادة، من ذلك لا على سبيل الحصر، إسقاط ركن القيام في الصلاة عمن لا يستطيعه، والزكاة عمن لم يملك النصاب، وفرض الصوم في رمضان عن المريض، والجهاد عن المرأة والصغير والمريض والأعرج والأعمى وغير ذلك، ومن قواعد الفقه الكبرى: المشقة تجلب التيسير، ولا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، فكل هذه القواعد شواهد على سماحة الإسلام ويسر الدين، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
الخصيصة الثامنة: الحكمة
والحكمة: تعني وضع الشيء في مكانه المناسب، والإصابة في القول والعمل. فهذه الدعوة مشتملة على الحكمة لأنها من لدن أحكم الحاكمين، الذي لا تنفك الحكمة عن أقداره وشرائعه جل وعلا، فيتعامل المسلم مع هذا الكون وهذه الكائنات على أنها خلقت لحكمة فلم تخلق عبثا – تعالى الله الملك الحق-، وكذلك شرائعه جل وعلا، فلم يأمر العباد بشيء ولم ينههم عن شيء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فيتلمس الداعية هذه الحكمة، ويبينها للناس لإقناعهم بها، ويبين لهم أيضا أن قدر الله أعظم من أن تحيط به العقول جل وعز، فالعقل سيقف مذهولا حائرا أمام بعضها قد خفيت عليه الحكمة منها، فيكل ذلك إلى عجزه عن إدراك الحكمة الإلهية مع يقينه بوجودها، فما يَعْلَمُ دليل على ما لا يَعْلَمُ، فيقول عند ذلك: “آمنا به كل من عند ربنا”.
الخصيصة التاسعة: صالحة لكل زمان ومكان
لأنها شريعة الله الحي القيوم، عالم الغيب، الخلاق العليم الذي يعلم ما توسوس به النفوس، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، البر الرحيم، العليم الحكيم.
فالخالق الصانع أدرى بصنعته، ومن كانت هذه صفاته فلا يكون أحد أبدا أحسن حكما منه جل وعلا، وقد خص الله عزّ وجل هذه الشريعة بأمور تضمن هذه الصلاحية إلى يوم القيامة وهي:
1- حفظه للمصادر وصيانتها من العبث، والمصادر الكتاب والسنة. أما الكتاب فتعهد الله بنفسه بحفظه فقال: “إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون” وهيأ لذلك الأسباب، منها: كثرة الحفظة والقراء لهذا الكتاب، وتناقله بالسند من جيل إلى جيل وبالتواتر منقطع النظير، حتى لا تكاد تجد طالب علم إلا وسنده متصل بهذا القرآن إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى الرب جل وعز وعلا، فلو رام أحد تحريف هذا الكتاب لرد عليه وكشفه طفل صغير في إحدى مجاهل أفريقيا من حفاظ كتاب الله عز وجل.
وأما السنة النبوية فحفظها من حفظ القرآن، لأنها تفسره، وتبين معانيه وأحكامه، وحفظها الله بعلماء الحديث رضي الله عنهم، فمحصوا الأحاديث وبينوا الصحيح منها والضعيف، وذلك عن طريق النظر في إسناده من الرواة والحكم عليهم بالجرح والتعديل، فلم يقبلوا الرواية من كل أحد، بل من كل ثقة عدل، أي ثقة في حفظه عدل في دينه، لم يجرب عليه الكذب، وتأكدوا من قوة حفظه وتحريه للصدق.
2- اشتمالها على أحكام عامة لا يمكن أن يخرج عنها شيء مما يحتاجه البشر في أعمالهم أو تعاملاتهم، وهي ما يسمى بالقواعد الفقهية وكذا علم مقاصد الشريعة، فهي شريعة مرنة، وأحكامها غالبا مبررة معلومة الحكمة، متوافقة مع العقل لا تعارضه، ومتناسبة مع الفطرة الَإنسانية غير المنحرفة، فيسهل على الفقيه في نوازل الأمور والأحداث تنزيلها على مقاصد الشرع وقواعده، وليس هناك قضية وقف الَإسلام أمامها بلا حكم أو حل، فسبحان العليم الحكيم القائل: “أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون”. وتبا لهاتيك العقول الفاجرة المعرضة عن هذا الشرع المطهر المستبدلة له بأحكام وضعية مليئة بالثغرات وضعها أصحاب أهواء لا ينظرون إلا بعقول قاصرة، ولا يرضون إلا بما يوافق أهواءهم ويضمن علوهم وفسادهم.
الخصيصة العاشرة: شريعة الإحسان
فلن يصلح بها حال الناس فقط، بل سترتقي بهم إلى أحسن الأحوال في كل مجال. قال الشيخ العلامة عطية محمد سالم رحمه الله في رسالته اللطيفة (محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية): “لَيْسَ من السهل على أَي إِنْسَان أَن يبين محَاسِن الشَّرِيعَة وَلَا أَن يعدد جَوَانِب الْإِحْسَان فِيهِ لِأَنَّهَا شَرِيعَة الْإِحْسَان، كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: “إِن الله كتب الْإِحْسَان على كل شَيْء”. وكل شَيْء: لم يخرج مِنْهُ وَلَا شَيْء حَتَّى فِي حَالَة الْقَتْل وإزهاق الرّوح فَلَا بُد من الْإِحْسَان وَفِي ذبح الْحَيَوَان وَفِي المحلات الَّتِي لَا يتَذَكَّر الْإِنْسَان فِيهَا معنى للإحسان. فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة” إِلَى آخر الحَدِيث.
ثمَّ لَو ذَهَبْنَا نتبع مرافق الْحَيَاة كلهَا لوجدنا الْإِحْسَان يُتَوِّجُها بل إِن الْغَايَة من خلق الْإِنْسَان وإماتته وإحيائه لم يكن لشَيْء إِلَّا للإحسان: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}. {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}.
وَفِي الحَدِيث بعد بَيَان الْإِسْلَام ثمَّ يتدرج إِلَى الْإِيمَان ثمَّ يتوج الْجَمِيع بِالْإِحْسَانِ إِنَّهَا صبغة الله {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ}.
وَلَو ذَهَبْنَا نعدد جَوَانِب الْإِحْسَان وَلَو على سَبِيل الْإِجْمَال نجد ابْتِدَاء من القَوْل بِاللِّسَانِ نجد قَوْله تَعَالَى: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. حَتَّى فِي الْجِدَال: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. وَفِي الدعْوَة إِلَى الله: {بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}. حَتَّى مَعَ الْمُسِيء: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ}. {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.
وَفِي الْعشْرَة الزَّوْجِيَّة إِذا لم تدم: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. وَمَعَ الْوَالِدين: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}.. إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ.. وأخيرا وَمن الْعُمُوم: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.
وَهَذَا أَمر من الله تَعَالَى بِعُمُوم الْإِحْسَان مَقْرُونا بِالْعَدْلِ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ}. إِنَّهَا شَرِيعَة الله أنزلت فِي كتاب أحكمت آيَاته ثمَّ فصلت من لدن حَكِيم خَبِير على من اصطفاه الله من خلقه وَخَاتم رسله بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رَحِيم. لخير أمة أخرجت للنَّاس تَأمر بِالْمَعْرُوفِ وتنهى عَن الْمُنكر وتؤمن بِاللَّه”. إلى آخر ما قال رحمه الله [ 20 – 21].
فهذه عشرة كاملة من الخصائص وهي أكثر من ذلك، ولعل ما ذكرت آنفا أبرزها.